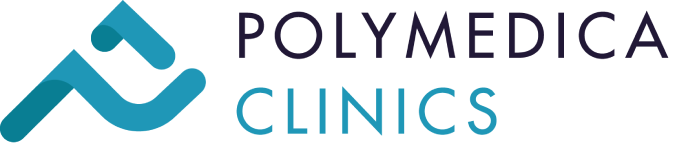حصوات الكلى هي أجسام صلبة تتكون من المعادن والأملاح الموجودة في البول. تتكوّن داخل الكليتين.
تتعدد أسباب تكوّن حصوات الكلى، ومنها النظام الغذائي، زيادة الوزن، بعض الحالات المرضية، وبعض المكملات والأدوية. يمكن أن تؤثر حصوات الكلى على أي عضو من الأعضاء المسؤولة عن تكوين البول أو إخراجه من الجسم، بدءًا من الكليتين وحتى المثانة. غالبًا ما تتكوّن الحصوات عندما يحتوي البول على كمية قليلة من الماء، مما يسمح للمعادن بتكوين بلورات تلتصق ببعضها البعض.
مرور الحصوات قد يكون مؤلمًا للغاية. لكن العلاج السريع عادةً ما يمنع حدوث أي ضرر دائم. أحيانًا، يكون العلاج الوحيد المطلوب هو تناول مسكنات الألم وشرب كميات كبيرة من الماء. وأحيانًا أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء جراحي أو علاجات أخرى، ويعتمد ذلك على حجم الحصوة، ومكانها، ونوعها.
إذا سبق لك الإصابة بأكثر من حصوة كلى، يستطيع جرّاح المسالك البولية إرشادك إلى طرق الوقاية من تكرارها. قد يشمل ذلك تغييرات غذائية، أو تناول أدوية، أو كليهما.
الأعراض
عادةً لا تُسبب حصوة الكلى أعراضًا إلا بعد أن تبدأ في التحرك داخل الكلية أو تنتقل إلى أحد الحالبين. الحالبان هما الأنبوبان اللذان يربطان الكليتين بالمثانة.
إذا علقت الحصوة في أحد الحالبين، فقد تعيق تدفق البول وتسبب تضخمًا في الكلية وتشنجًا في الحالب، مما يؤدي إلى ألم شديد. في هذه الحالة، قد تظهر عليك الأعراض التالية:
- ألم حاد وشديد في الجانب والظهر، أسفل الأضلاع.
- ألم ينتقل إلى أسفل البطن والمنطقة الأربية.
- ألم يأتي على شكل موجات ويختلف في شدته.
- ألم أو إحساس بالحرقة أثناء التبول.
وقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:
- بول وردي أو أحمر أو بني اللون.
- بول عكر أو ذو رائحة كريهة.
- رغبة مستمرة في التبول، أو التبول أكثر من المعتاد، أو التبول بكميات صغيرة.
- غثيان وقيء.
- حمى وقشعريرة في حال وجود عدوى.
قد يتغير الألم الناتج عن حصوة الكلى أثناء تحرك الحصوة في المسالك البولية. على سبيل المثال، قد ينتقل الألم إلى مكان مختلف في الجسم أو يزداد في شدته.
متى ينبغي زيارة جرّاح المسالك البولية
احجز موعدًا مع جرّاح المسالك البولية إذا ظهرت عليك أي أعراض تثير قلقك.
ويجب الحصول على تقييم طبي عاجل إذا كنت تعاني من:
- ألم شديد لدرجة أنك لا تستطيع الجلوس أو إيجاد وضع مريح.
- ألم مصحوب بغثيان وقيء.
- ألم مصحوب بحمى وقشعريرة.
- وجود دم في البول.
- صعوبة في التبول.
الأسباب
غالبًا لا يكون لحصوات الكلى سبب محدد واحد. لكن هناك العديد من العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بها.
تتكون الحصوات عندما يحتوي البول على كميات كبيرة من المواد التي تُشكّل البلورات، مثل أوكسالات الكالسيوم، فوسفات الكالسيوم وحمض اليوريك، وفي الوقت نفسه، يفتقر البول إلى المواد التي تمنع البلورات من الالتصاق ببعضها البعض. هذا يخلق بيئة مثالية لتكوين الحصوات.
أنواع حصوات الكلى
معرفة نوع الحصوة يساعد جرّاح المسالك البولية في تحديد السبب ووضع خطة العلاج المناسبة. كما أن هذه المعلومات تفيد في الوقاية من تكرار الحصوات. إذا استطعت، حاول الاحتفاظ بأي حصوة تمر بها، وقدمها إلى الطبيب لفحصها وتحليلها.
تشمل أنواع الحصوات ما يلي:

- حصوات الكالسيوم: معظم حصوات الكلى هي من هذا النوع، وغالبًا ما تتكون من أوكسالات الكالسيوم. الأوكسالات مادة يُنتجها الكبد يوميًا أو تُمتص من الطعام. تحتوي بعض الفواكه والخضروات، وكذلك المكسرات والشوكولاتة، على كميات عالية من الأوكسالات. قد تزداد كمية الكالسيوم أو الأوكسالات في البول بسبب عوامل غذائية، جرعات عالية من فيتامين د، عمليات تحويل مسار الأمعاء، وبعض الأمراض التي تؤثر على التمثيل الغذائي. يمكن أيضًا أن تتكوّن حصوات الكالسيوم من فوسفات الكالسيوم، وهو نوع أكثر شيوعًا في حالات مثل الحماض الأنبوبي الكلوي (خلل في أنابيب الكُلى يمنعها من طرد الأحماض فيرتفع الحامض في الدم)، وقد يكون مرتبطًا باستخدام أدوية مثل Topiramate (Topamax, Trokendi XR).
- حصوات حمض اليوريك: يمكن أن تتكون لدى الأشخاص الذين يفقدون كميات كبيرة من السوائل بسبب الإسهال المزمن، أو الذين يعانون من سوء امتصاص في الجهاز الهضمي، أو يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين أو اللحوم العضوية أو المأكولات البحرية، وكذلك في حالات مرض السكر والضغط وإرتفاع نسبة الدهون. كما قد تساهم العوامل الوراثية في ذلك.
- حصوات الستروفيت: تتكوّن استجابةً لحدوث عدوى في المسالك البولية. قد تنمو هذه الحصوات بسرعة وتصل إلى أحجام كبيرة، أحيانًا دون ظهور أعراض واضحة.
- حصوات السيستين: تتكوّن لدى الأشخاص الذين يعانون من السيستينوريا، وهي حالة وراثية نادرة تجعل الكلى تُسرّب كميات زائدة من حمض السيستين، وهو أحد الأحماض الأمينية.
عوامل الخطر
تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى:
- التاريخ العائلي أو الشخصي: إذا كان أحد أفراد عائلتك قد أُصيب بحصوات الكلى، فأنت أكثر عرضة لتكوّنها. وإذا سبق لك الإصابة بحصوة، فإن خطر تكرار الإصابة يزداد.
- الجفاف: عدم شرب كمية كافية من الماء يوميًا يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى. الأشخاص الذين يعيشون في مناخ حار وجاف، أو الذين يتعرقون كثيرًا، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة.
- بعض الأنظمة الغذائية: النظام الغذائي الغني بالأوكسالات، البروتين، الصوديوم والسكر يزيد من خطر بعض أنواع الحصوات، خاصة في حالة ارتفاع الصوديوم. الإفراط في تناول الصوديوم يؤدي إلى زيادة كمية الكالسيوم التي تُرشّحها الكلى، مما يرفع خطر تكوّن الحصوات.
- السمنة: تُعد السمنة من الأمراض المعقدة المرتبطة بزيادة خطر تكوّن الحصوات.
- أمراض الجهاز الهضمي والعمليات الجراحية: مثل عمليات تحويل المسار المعدي، التهاب الأمعاء المزمن أو الإسهال المستمر، يمكن أن تُغير من عملية امتصاص الكالسيوم والماء، مما يؤدي إلى زيادة المواد المُسببة لتكوّن الحصوات في البول.
- أمراض صحية أخرى مثل الحماض الأنبوبي الكلوي، السيستينوريا، فرط نشاط الغدة الجار درقية، والتهابات المسالك البولية المتكررة قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة. كما أن حالة وراثية نادرة تُعرف باسم فرط أوكسالات الدم الأولي تزيد من خطر تكوّن حصوات أوكسالات الكالسيوم.
- بعض المكملات والأدوية: مثل فيتامين C، مكملات غذائية، الإفراط في استخدام الملينات، مضادات الحموضة المحتوية على الكالسيوم، وبعض أدوية الصداع النصفي أو الاكتئاب.
الوقاية
تغييرات في نمط الحياة
يمكنك تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى إذا قمت بالتالي:
- شرب كميات وفيرة من الماء: يُنصح بأن تشرب كمية كافية من السوائل تُنتج ما لا يقل عن 2.5 لتر من البول يوميًا. إذا كنت تعيش في بيئة حارة أو تمارس الرياضة أو تتعرق كثيرًا، فستحتاج إلى كمية أكبر من السوائل.
- التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالأوكسالات: مثل السبانخ، الشمندر، المكسرات، الشوكولاتة، البطاطا الحلوة، والشاي.
- تقليل استهلاك الملح والبروتين الحيواني: تناول كميات زائدة من الملح أو البروتين الحيواني مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية يزيد من خطر تكوّن الحصوات.
- اتباع نظام غذائي متوازن: يحتوي على كميات معتدلة من الكالسيوم من مصادر غذائية طبيعية، لأن نقص الكالسيوم في الطعام قد يزيد من امتصاص الأوكسالات.
- مراجعة أخصائي تغذية: للمساعدة في إعداد خطة غذائية مناسبة حسب نوع الحصوة التي أُصبت بها سابقًا.
الأدوية
يمكن أن يصف لك جرّاح المسالك البولية أدوية تساعد على تقليل خطر تكوّن الحصوات، حسب نوع الحصوة. الأمثلة تشمل:
- Thiazide diuretics: تُستخدم لتقليل مستوى الكالسيوم في البول.
- Allopurinol: لتقليل حمض اليوريك في البول في حالة وجود حصوات من نوع حمض اليوريك.
- Potassium citrate: لزيادة قلوية البول ومنع تكوّن حصوات من حمض اليوريك أو السيستين.
- أدوية تقلل امتصاص الأوكسالات أو تساعد على ذوبانها في البول.
التشخيص
يبدأ التشخيص عادة بعد أخذ التاريخ المرضي وإجراء الفحص السريري، ثم طلب بعض الفحوصات لتحديد موقع الحصوة، حجمها، ونوعها:
- تحليل البول: للكشف عن وجود دم أو مواد مكونة للحصوات، أو علامات عدوى.
- تحاليل الدم: لقياس مستوى الكالسيوم، حمض اليوريك، وظائف الكلى، والكهارل.
- الأشعة المقطعية بدون صبغة (CT): تُعد الأدق لتحديد حجم وموقع الحصوة.
- أشعة سونار على البطن والحوض (Ultrasound): تُستخدم كبديل للأشعة المقطعية، خاصة للحوامل أو الأطفال.
- الأشعة السينية (X-ray): قد تُستخدم لمتابعة الحصوات المحتوية على الكالسيوم، لكنها لا تُظهر جميع أنواع الحصوات.
- تحليل الحصوة: إذا مررت الحصوة في البول، يمكن تحليل مكوناتها في المعمل.
- التحاليل الوراثية: تُطلب في حالة الاشتباه في أمراض وراثية مثل السيستينوريا أو فرط أوكسالات الدم الأولي، وقد يُوصي بها جرّاح المسالك البولية حسب الحالة.
العلاج
يعتمد العلاج على حجم الحصوة، موقعها، نوعها، والأعراض المصاحبة. ويتراوح بين العلاج التحفظي والجراحي:
الحصوات الصغيرة والأعراض البسيطة
في أغلب الحالات، تمر الحصوات الصغيرة من تلقاء نفسها عند اتباع الخطوات التالية:
- شرب كميات كبيرة من الماء (حتى 3 لتر يوميًا) لتسهيل خروج الحصوة.
- تناول مسكنات الألم مثل Paracetamol أو NSAIDs (مثل Ibuprofen أو Diclofenac).
- أدوية تُساعد على مرور الحصوة: مثل
- Tamsulosin (Tamsulin)
- أو تركيبة Dutasteride + Tamsulosin (Duodart)
حيث تعمل على إرخاء الحالب لتسهيل نزول الحصوة.
الحصوات الكبيرة أو المعقدة
قد لا تمر بعض الحصوات من تلقاء نفسها، وهنا قد يُوصي جرّاح المسالك البولية بأحد التدخلات التالية:
- تفتيت الحصوة بالموجات الصدمية من خارج الجسم (ESWL): يُستخدم لتفتيت الحصوة إلى قطع صغيرة يسهل خروجها في البول.
- المنظار الداخلي للحالب (Ureteroscopy): يتم إدخال منظار عبر مجرى البول إلى الحالب، ويمكن إزالة الحصوة أو تفتيتها باستخدام الليزر.
- جراحة المنظار عن طريق الجلد (PCNL): تُستخدم للحصوات الكبيرة أو التي تقع في مكان يصعب الوصول إليه بالمنظار الداخلي.
- جراحة الغدة الجار درقية: في حالات فرط نشاط الغدة الجار درقية، حيث تؤدي إلى زيادة الكالسيوم وتكوّن الحصوات، قد يكون التدخل الجراحي ضروريًا.